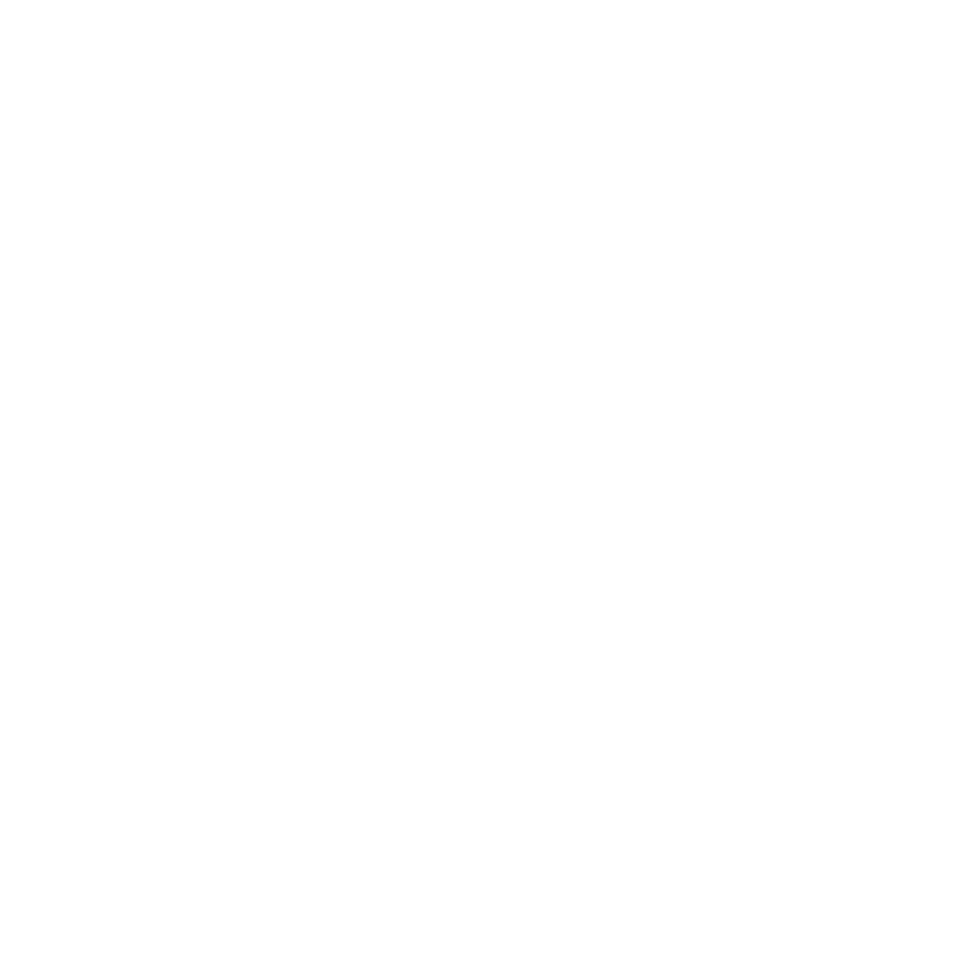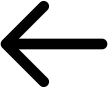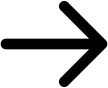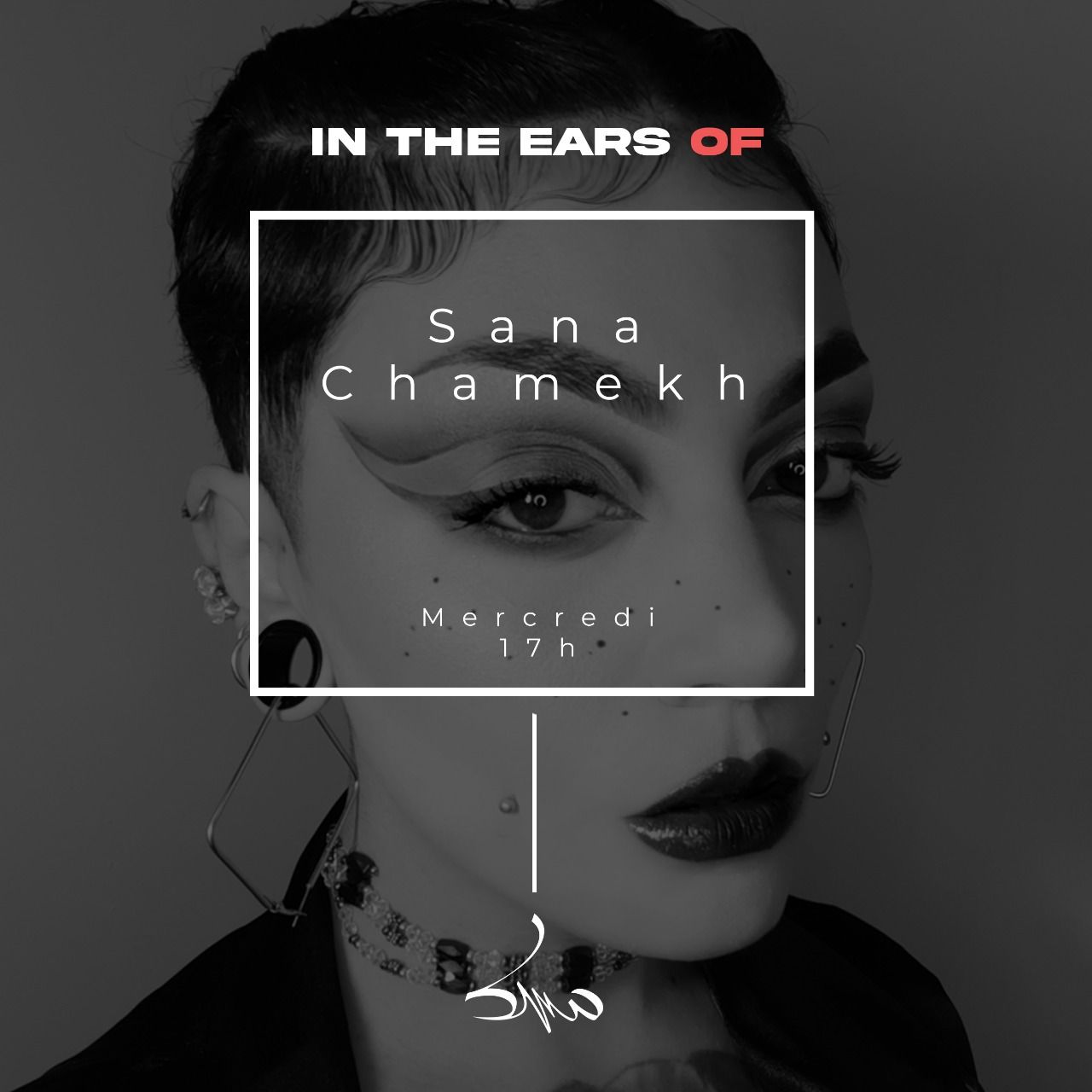يتحدث البعض عن طفرة في إنتاج السينما المستقلة وسينما المؤلف العربية خلال السنوات العشر الأخيرة، ويتحدث آخرون عن انتشار عالمي لم يسبق له مثيل وآخرون عن دور الثورات العربية في تحرير الأفكار التي ظلت لعقود مكتومة، لكن أمورا أخرى كانت تغلي تحت براكين اليوم، هم شباب لا يرون واقعهم وبلدانهم كما روجتها سينما آبائهم وأجدادهم وبالتالي هم لا يرون السينما كما رآها ويراها كل من سبقوهم. نتحدّث عن سينما أخرى جديدة تنبثق من أعماق القاع حاملة لواء الفرد لترفع راية المجموعة.
لسنا بصدد الحديث عن سينما آتية من العدم، وهي ليست نتيجة لقطيعة مع شكل أو أشكال سينمائية ما، لكنها فقط تعدد زوايا النظر لوقائع وأحداث ما وتكثّف مقترحاتها الجمالية المتراوحة بين قمة البساطة وأقصى مراحل التجريب.
في العشرية الأخيرة، لنا أن نتحدث عن عشرات الأفلام العربية التي بقيت حديث الجمهور والنقاد لفترات طويلة. بكل ذاتية، اخترنا لكم ما شد انتباهنا خلال السنوات العشر الأخيرة.
أطلال لجمال كركار
لم يكن جمال كركار مخرجا في هذا الفيلم، لكنه كان شاعرا بامتياز، شاعرا صامتا يتأمل بكل خشوع في الأشياء فتنطق بفيض بعد سنوات طويلة من الامتناع عن الكلام.
من بين أنقاض قرية أولاد علال الجزائرية، قام جمال كركار بتصوير فيلم عن العشرية السوداء. في هذه القرية، لكل شبر من اﻷرض قصة طويلة مع الإرهاب، مع الرعب، مع رائحة الدم والموت، كل شيء حتى الأبواب وبقايا الجدران والعشب والأشجار. أما الناس، فكان عليهم الإمتناع عن الحديث لساعات طويلة أمام الكاميرا، لم نعش منها سوى دقائق لكننا استطعنا بفضل شاعرية ما في الفيلم أن نشعر بثقل مرورها عليهم، ساعات من السرحان الطويل في دواخل متألمة، تفضي في النهاية لجمل قاهرة أو لدموع تروي تاريخا من الخسارة طويل.
آخر أيام المدينة لتامر السعيد
القاهرة، وسط المدينة، ديسمبر 2009. يحاول خالد، صانع الأفلام الشاب، أن يصنع فيلماً يلتقط فيه نبض المدينة في لحظة يكاد أن يفقد فيها كل شيء. بمساعدة رسائل الفيديو التي تصله من أصدقاءه في بيروت وبغداد وبرلين، على خالد أن يجد طريقه عبر قسوة وجمال آخر أيام المدينة
عن محتوى الفيلم، يجيبنا تامر السعيد بكلّ اقتضاب" هو فيلم عن ازاي شخص يواجه العالم وهو ينهار من حوله، وهو وحيد". القاهرة مكان مكتضّ، يعجّ بالخلق والمخلوقات وبالأشياء، بها أضعاف من كلّ شيء يمكن أن نراه بمدينة أخرى، لا تعطي سوى بغزارة، لذلك هي لا تأخذ سوى بكثافة. كلّ هذا نراه في الفيلم، نشعره ونعيشه بقوّة، في الأصوات المتعالية لكلّ شيء، الناس والسيارات والأشغال والاحتفالات والمظاهرات وفي الحركة أيضا وطبيعتها، نراه وراء زجاج المغازات وعلى وجوه المارين وفي المباني وفي الصمت. في الفيلم، لا يخرق تامر السعيد القاعدة بل يؤكّدها، أنّنا لا نعيش وحدتنا ولا نمارس فعليّا صمتنا سوى في قلب الاكتضاض، وأنّه ليس هناك أرضيّة خصبة أكثر من الفوضى والضغط، حتى نلتفت إلى أنفسنا، فلا معنى لدواخلنا لو لم نجد لها انعكاسات في كلّ ما يحيط بنا. هكذا كان خالد، شخصيّة الفيلم، يتغذّى من المشاهدة والاستماع واللمس، لأنّ فيض القاهرة بكلّ شيء يغذّي الحواس. لا يوجد أيّ سرّ في الفيلم، لا غموض ولا ما يدعو للفضول، لقد تعرّت المدينة أمامنا وأمام تامر، عاشقها، الذي قدّم لنا من خلال الفيلم فرصة للتوقّف أمامها وتأمّلها دون أن نكون مجبرين على الرّكض وراء نسق سريع أو حدث نأمل أن يحصل. لا يوجد حادث قادح، لا نهاية سعيدة ولا تراجيديا ولا أيّة عقدة، نحن في " آخر أيّام المدينة"، أمام حالة انهيار ثابتة وسقوط متواصل دون أيّة نهاية.
آخر واحد فينا لعلاء الدين سليم
هناك في تلك الزاوية المظلمة من العالم، يشعل علاء الدين سليم الضوء في كهوف ومغارات مهجورة من السينما. لا نعلم اذا كان الإختلاف عن الموجود قرارا أو أمرا بديهيا بالنسبة له، لكننا نعلم أن في الحديث عن علاء الدين سليم، نجد أنفسنا أمام الوجه الآخر؛ للسينما، للضوء، للمدينة، للطبيعة وللجنس البشري.
آخر واحد فينا، هو قصة شاب من جنوب الصحراء الإفريقية يقرر عبور الضفة الجنوبية للمتوسط نحو الضفة الشمالية، لكنه يتيه في مكان مجهول، ليخوض رحلة استكشافية يواجه فيها مواقف لم يكن ينتظرها. نحن أيضا لم نكن ننتظر كمشاهدين ذلك الكم من الراديكالية في الغوص في الحياة البرية ضاربا على عرض الحائط كل "القيم" الإنسانية مغنيا نشيد المطلق والماوراء.
هذا الفيلم-الحالة، لا يعكس فقط عزلة المخرج وانفراده، بل يحيلنا على فهم جيل كامل من المتطرّفين في فنّهم الذين هاجروا بأفكارهم فوقعوا في غبة بين ذويهم. دون هوية محددة، آخر واحد فينا هو قصة كبيرة بحجم الكون لإنسان وجد "الحل".
ضربة في الرأس لهشام العسري
ما يفعله العسري بضربة في الرأس، هو إدخالنا في عالمه الخاص من التجريب الاستيتيقي، بكاميرا لا تكفّ عن التحرّك في اتّجاهات كثيرة، فنتنقّل عن طواعية معها ودون وعي شمالا وجنوبا وسماء وأرضا، حركة تصل إلى الدوران الذي يشعرنا بدوار وارتجاج. لم تنته عمليّة التكثيف التي انتهجها العسري في الفيلم عند حركة الكاميرا، إنّما عند الألوان الفاقعة في الفيلم، فنتفرّج كما لوكنّا تحت تأثير مخدّرات قويّة، تجعل منّا نرى الألوان بشكل أصفى وأدقّ من الحالة العادية للنظر. كلّ هذا والتمثيل الكاريكاتوريّ للشخصيّات، يجعل من الموقف واضحا وضوح الشّمس: نحن أمام هيستيريا جماعيّة لشعب لم يتجاوز أثر الظروف التي مرّ بها، شعب يعيش تحت نظام تنويميّ ولا يستطيع استيعاب حالته الداخليّة ولا تصريف مشاعره المتناقضة في رد فعل محدّد ومتناسق، نحن أمام الحقد الذي يملأه الخوف وأمام النكران.
الحديث عن الأشجار لصهيب قاسم البري
فيلم بكل بساطة جميل جدا، لا يتطلب الخوض في فلسفة عظيمة لتحليله وفهمه. نحن أمام تكريم للسينما السودانية، لكنه تكريم مختلف جدا، لأنه غارق في الواقعية.
يدور الفيلم حول أربعة مخرجين سودانيين، هم: سليمان محمد إبراهيم، وإبراهيم شداد، ومنار الحلو، والطيب مهدي، قاموا بتأسيس جماعة الفيلم السوداني عام 1989 والتي تمارس نشاطًا ثقافيًّا سينمائيًّا ويشرف مؤسسوها على تنظيم العروض السينمائية المتواضعة بمقر الجمعية وعدد من القرى. تبدأ الأحداث في عام 2015، إذ يسعى المخرجون الأربعة لتنظيم عرض سينمائي واسع بمدينة أم درمان، من خلال إعادة تأهيل إحدى دور العرض المغلقة منذ ثلاثة عقود، ولكنهم يصطدمون بالروتين البيروقراطي، وتحول الموافقات الأمنية بينهم وبين مسعاهم.
في راسي رونبوان لحسان فرحاني
في أكبر مسلخ في الجزائر العاصمة ، يعيش العديد من العمال خلف أبواب مغلقة بإيقاع ممل ومرهق. يتحدثون عن الأمل ، المرارة ، الحب ، الجنة والجحيم ، كرة القدم وغيرها من المواضيع، على أنغام الفن الشعبى وموسيقى الراي التى أصبحت كل حياتهم وعالمهم.
يلبس الفيلم ثوب الحزن والرتابة بكل أناقة ويقف بتمعّن أمام قطعة من الجزائر، نراها ربما كل يوم في بلداننا، لكنّنا لم نهتم يوما للإستماع لها.
أخضر يابس لمحمد حمّاد
هو فيلم روائي طويل للمخرج المصري محمّد حمّاد يروي قصّة أختين تعيشان بمفردهما معا، تدرس الصغرى في الجامعة وتستعد للزواج، وتتولى الثانية الأمور المالية للمنزل باشتغالها في محل بيع الحلويات.
. يندرج فيلم أخضر يابس ضمن هذه الحركة الجديدة للأفلام المصرية والتي، من أجل التعبير عن واقع محليّ أو انسانيّ عام، تنطلق من حياة الأفراد، إيمانا بكون أنّ هذا الفرد هو عالم بأسره يعكس كلّ أركان البلد الذي يعيش فيه، هذا البلد الذي هو "مصر"، والذي نراه في "أخضر يابس"، بعيدا جدا عن كليشيهات الفوضى والحياة الضاجة بالحركة والحوارات، ليس مصر الغناء الشعبي والرقص الدائم والباعة التي تعلو حناجرهم بالإعلان عن منتوجاتهم ولا حتى المقاهي التي لا تشغر، لا نشاهد كلّ هذا، بل نحن أمام أمكنة تعكس دواخل شخصياتها، حزينة وتشعر بالملل الدائم، تغمر أوجهها علامات التفكير اللامنقطع ويعلو محيّاها التوهان.
الخروج للنهار لهالة لطفي
تأليف وإخراج هالة لطفي، تدور أحداث الفيلم حول محنة أسرة فقيرة فى أحد أحياء القاهرة الشعبية، متكونة من أب مقعد (أحمد لطفي)، وأم ممرضة (سلمى النجار)، مع ابنتهما (دنيا ماهر) تواجه مشاكل في التعبير عن مشاعرها وأحلامها بعد أن أصبحت فى الثلاثين من عمرها ولم ترتبط بعد، ولا تفعل شيئاً سوى رعاية أب غائب عن العالم.
ينتمي الفيلم إلى نفس العالم الذي يتموقع فيه "أخضر يابس"، لكنه يتجاوز الفردانية ليخوض غمار الوحدة في أقسى تجلياتها. فيلم نجحت من خلاله هالة لطفي في تحويل الزمن إلى شخصية رئيسية، نشعر بحركتها البطيئة وبقوامها الكسيحة ووزنها الثقيل جدا. مرور الزمن في هذا الفيلم، هو أشبه بموت بطيء، موت لليال طويلة من الأحلام، من الأنوثة والدلال والضحكات والعناقات، مرور لنا أن نرى من خلاله اليومي وحشا يلتهم الأمنيات وكل المتع والملذات التي غابت عن روح الفيلم وألوانه. عمل استثنائي في بساطته، جعلتنا هالة لطفي من خلاله نرى الحياة التي لم تكن عبر واقع مختنق وفارغ.
حادثة النيل هيلتون لطارق صالح
“كانت قصّة "حادثة في نيل هيلتون" مرتبطة باستمرار بالواقع. (…) هذا الفيلم، هو عن مدينة أحبّها. هو عن التصادم بين الماضي والمستقبل، وعن الناس التي تمّ سحقها مابين بين.”
هي مقولة تلخّص تقريبا كلّ شيء، وتؤكّد ضرورة الانصهار في الفرجة دون التعسّف على الفيلم بانتظارات معيّنة أو تخيّل نهايات واردة لأنّ كلّ الأمور واضحة لدى المخرج بشكل مريب. نحن قبل أيّام من أحداث "25 يناير"، نتابع حياة ضابط شرطة فاسد، مكتئب ومدمن على المخدّرات، ونعيش معه بحثه في ملابسات قضية مقتل فنانة تونسية في نزل النيل هيلتون العالمي بالقاهرة.
تجمع اللقطات الخارجية، والتي تم تصوير أغلبها من خلال شباك سيارة البطل، بين الفراغ والهدوء التام، أثراهما صمت نورالدين شبه التام وندرة الحوارات أو قصرها، فنجد أنفسنا، بالإضافة إلى وجه فارس الزاهد أحيانا والواهن أحيانا أخرى، أمام لغة سينمائيّة سكوندينافيّة بامتياز، لا يحمينا من برودها القاتل سوى تلك المسحة الدافئة التي غطّت كامل الفيلم بلون مصفرّ خاص بالسينما الشرقية، وبخيارات الأغنيات المصرية الكلاسيكية التي ترافق سفر البطل. بهذه الطريقة عالية الدقة، نتّخذ وقتنا في استيعاب مانحن أمامه خلال اللّقطات الطويلة وبفضل نسيج دراميّ لم تقم حبكته على الإثارة المفتعلة، إنّما تتحوّل فيه المفاجاءات إلى أحداث عاديّة تهزّ قلوبنا دون أن ننتفض، كما لو كنّنا تحت تأثير منوّم أومستحضر ينمّي مناطق التركيز في أدمغتنا فننصهر داخل الفيلم تاركين القيادة لصاحبه.