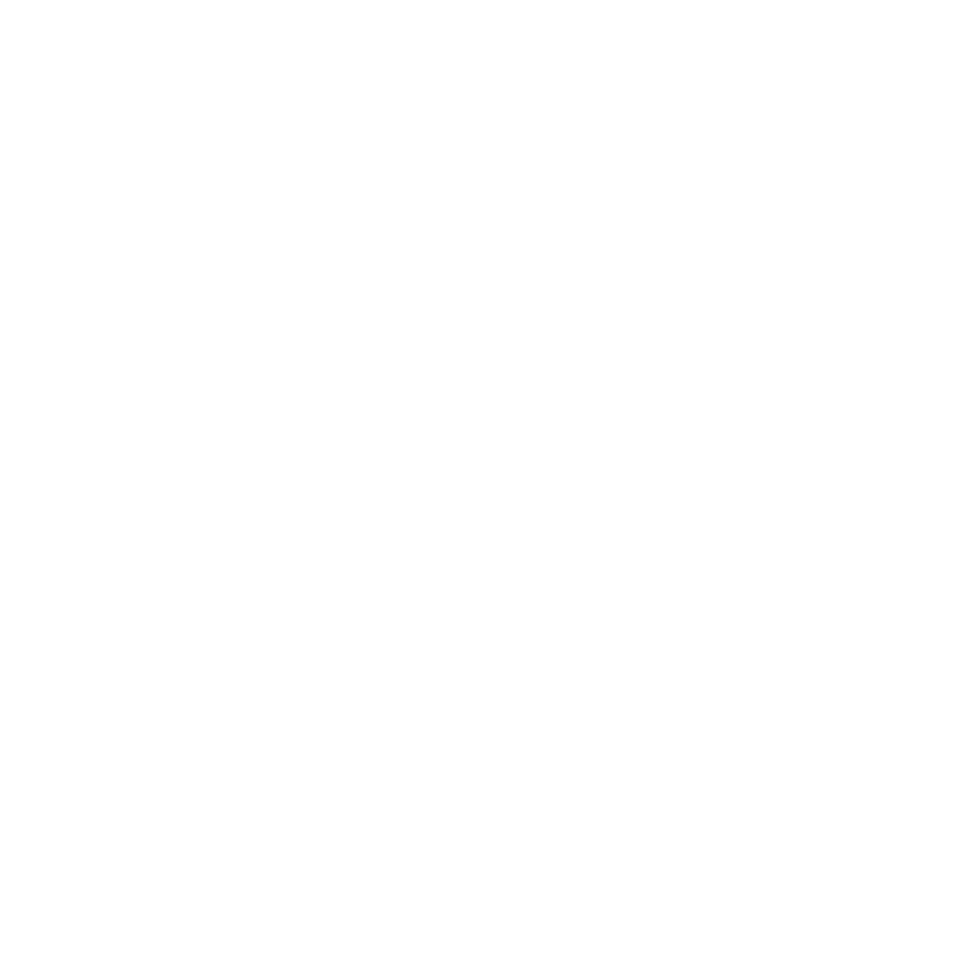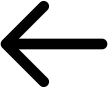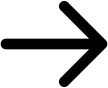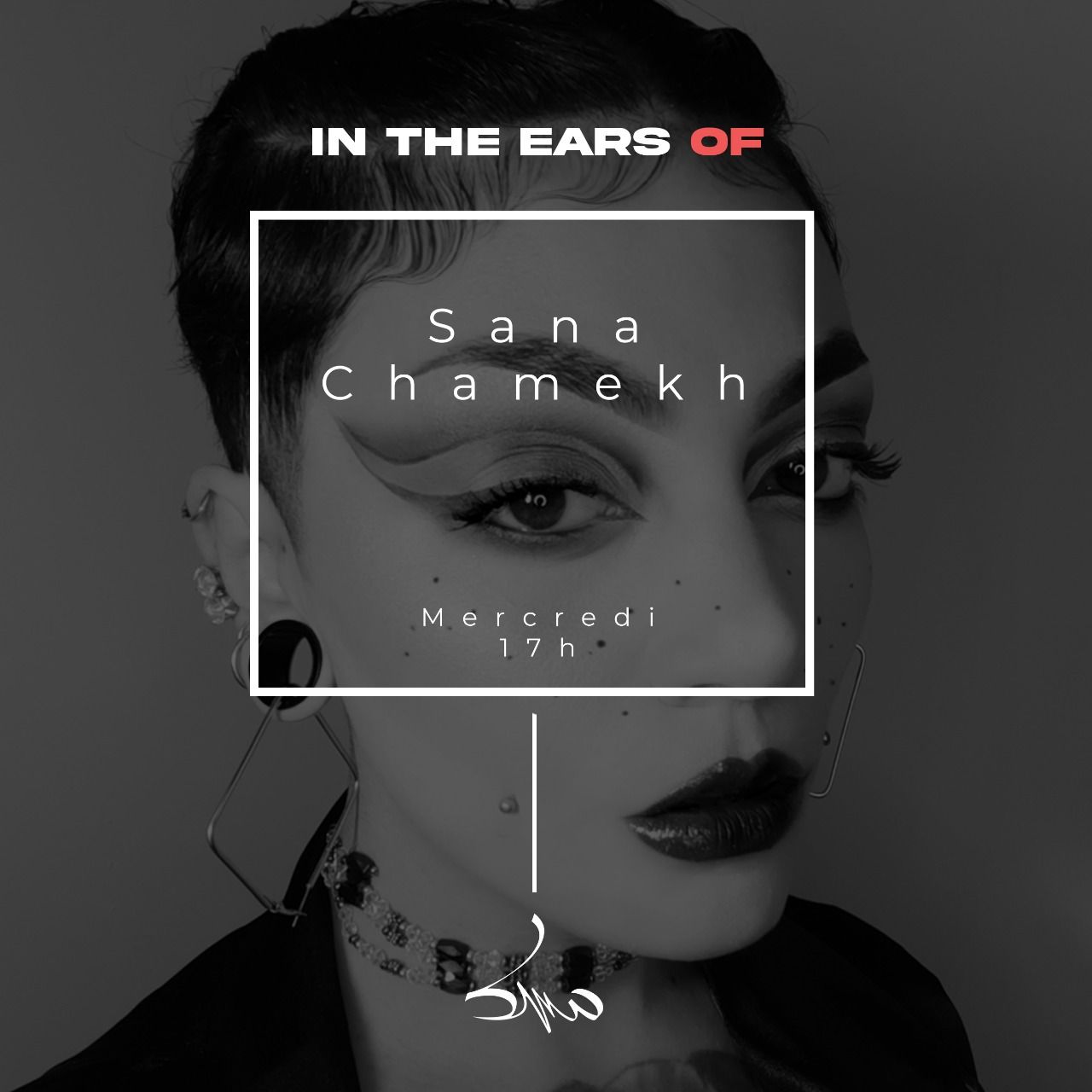قد نحتاج لاستجماع كلّ ما أوتينا من حزن حتى نكتب عن سيكاتريس، العمل المسرحي الأخير لغازي الزغباني.
قد نضطر إلى استرجاع كلّ المشاهد الحزينة من الأفلام، أو أن نفرغ مكاتبنا من كلّ الأفكار التي تدعونا للتموضع في عالم مختلف عن ذلك الذي هربنا منه صباحا في الحافلات أو على متن التاكسي حتى ننساه ونعود إليه ليلا للنوم. حتى نكتب عن عمل فني حزين، وجب أن نستحضر الواقع ونضعه أمامنا، هكذا، قبالة المكتب، بعد إزاحة بعض الأوراق ووعاء السمكة والحاسوب، لا! فلنترك الحاسوب ونختصره فقط في كونه آلة كاتبة. سنتعسّف قليلا على ذاكرتنا، ونفكّر في ما رتّبه النكران في أدراج النسيان في أدمغتنا، كصور ذلك السكّير في حيّنا، من تتلاقفه الجدران ليلا وتأويه صباحا، وتفرّ منه الفئران ولا أحد يعي ما به، يمرّ أيضا على مسامعنا صراخ امرأة من شدة الضرب وتدخّل كبار الحي وكبيراته بالصلح المؤقت دوما، حلقة مفرغة من الصلح والشجار لا تنتهي سوى بموت الرجل في أغلب الأحيان، جراء نيران اشتعلت بصدره ذات ليلة، تبكي الأمّ وأبناؤها حزنا على حياة كان يمكن أن تكون، يتنفّسون الصعداء ويقولون معا: "الله يرحمو".
مقدّمة شخصيّة، لعمل لا يخاطب سوى ذواتنا الصغيرة التي نطويها صباحا بين رفوف الملابس ونرحل للحياة. عمل يتموقع بكل تفاصيله ضمن توجّه فنيّ أبديّ، وهو أنّ مأساة الجماعة تبدأ عند مأساة الفرد وتنتهي إليها.
مأساة بطل سيكاتريس هي الحياة تحت وطأة نظام قمعيّ بفكر حرّ ورغبة في الانعتاق، ودخوله منذ البداية في حرب خاسرة ضد نفسه أولا وضد الجميع ثانيا.
تنبش المسرحية في واقع تونسيّ عميق ومتجذّر في ثقافة هذا البلد وشعبه، الهروب إلى الكحول كحلّ أوّليّ وأخير من كلّ المآسي والنكبات اليومية والوجودية. البيرة في ثقافتنا، هي الإجابة المطلقة على كلّ الأسئلة التي لا إجابة لها من نوع "لماذا أنا؟"، "لم يحصل بي هذا"؟ و"متى ينتهي هذا كلّه؟". أمّا العنف، وصبّ الغضب على المرأة وتحميلها كامل المسؤولية في ما اقترفته وما لم تفكّر يوما في فعله، فهو فنّ يتقنه الرّجال بكلّ غريزية وبديهية. هكذا تعاني نادية بوستة بطلة العرض، من الوحدة واللامبالاة والتأثيم اليومي من قبل زوجها على خطإ لا أحد يعلم إن كانت قد تسببت به أم لا.
راقصة في كاباريه، مثيرة وجامحة بفتنتها وجمالها، تعرفت على زوجها (محمد حسين قريع) في إحدى السهرات الراقصة، كانت حينها في أوج سحرها، وكان وقتها المثقف الماجن، صحفيّ أنيق وذكيّ، أحبّا بعضهما وتزوّجا ليركبا معا قطار الحزن والبؤس. هكذا تبدأ القصة التي لا نكتشفها سوى وسط العرض في عملية فلاش باك سينمائية بامتياز، متقنة الإخراج ونادرة الوجود على خشبة المسرح في تونس.
يخسر بطلنا كلّ شيء، وظيفته جراء تمسّكه بإبداء موقف يعارض ما يريد النظام ترويجه في ما يتعلق بقضية حرب العراق، يخسر زوجته التي أصبح يعنّفها كلّ ليلة عند عودته ثملا، وينتهي به كلّ شيء إلى مستشفى الأمراض العقلية "الرازي".
في سيكاتريس، لا يروي الشخصيات حكايتهم، إنّما يحملونها على ظهورهم المنحنية وضحكاتهم الفاحشة، هناك دوما من يتكلّم في محلّهم ليقدّمهم ويعطينا لمحة عن ماضيهم وعن تطلّعاتهم، لاعبين بذلك دور المحرك للأحداث. لكن الأدوار تتشابك في بعض الأحيان، في حالات تمرّد عابرة تنتهي بالفشل. نتنقّل في سيكاتريس بكلّ سلاسة بين الأماكن، من البار إلى الكاباريه إلى المنزل وإلى مقرّ الجريدة، هنا تلعب الإضاءة دورها وتتحكّم الشخصيات في الديكور في حركات بغاية الدقة والانسجام.
تحفر سيكاتريس في واقع ماديّ، نعيشه كلّ يوم، في هشاشة الفرد الذي لم تحصّنه ظروفه من السقوط السريع وسط البؤس والانهيار، وتقدّم لنا في مكان حميميّ، فضاء الأرتيستو"، قصة حميميّة عن مأساة العيش في بلد حزين كهذا.